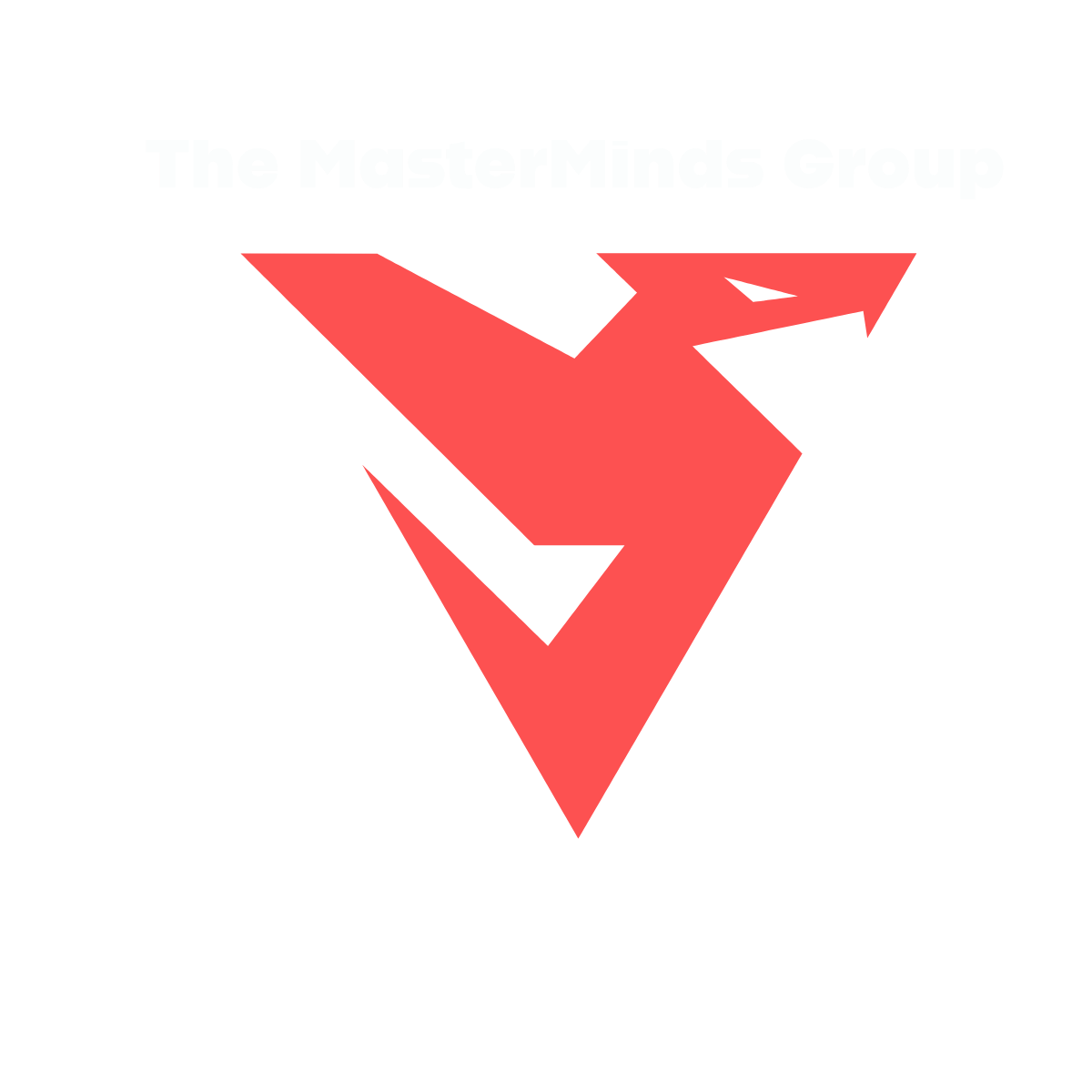التالي هو من كتاب من الفكر والقلب للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

بدأ السائل حديثه فيما يستشكله، بقوله: هل الإنسان مخيّر فيما كلّفه الله به أم مسيّر؟
فقلتُ: إنّ من تصرفات الإنسان، ما هو مخيّر فيه، كالسعي إلى طعامه وشرابه، والقصد إلى أغراضه وخواطره، من كلّ ما لا يفعله إلّا برجحان من إرادته وعقله. ومنها ما هو مسيّر فيه، كحركة الارتعاش والوقوع والانزلاق، وما يفعله مكرهاً، من كلّ ما يصدر منه بدون وحي من إرادته وعقله.
وفارق الإرادة هذا، فارق جليّ يهدي في حياة الإنسان، لا يقبل أي جدل أو إمراء. كما أنها حقيقة أثبتها القرآن الكريم للإنسان بصريح العبارة
التي لا تقبل أي تحريف أو تأويل، وذلك في مثل قوله تعالى: «لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين» [التكوير: 28-29]، وقوله: «فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا» [الإنسان: 29]، وقوله: «فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ * وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ» [المدثر: 55-56].
ومن أهم شروط صحة التكليف أن يكون المكلّف مختاراً فيما يتعلّق بالتكليف به. فلا يبدأ صحّة التكليف، إلّا حيث يتوافر الإخبار، ويثبت جيّد أن يصبح الإنسان مكلّفاً قائداً لإرادته وطباعه. وهذا القانون جليّ صريح في قوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286]، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»
قال: فإذا كان كما تقول، فما معنى أن الله قدّر وقضى على الإنسان كلّ ما يكسبه من خير وشر؟ وكيف يبقى للإنسان مع ذلك أيّ اختيار في فعل ما يريد؟ فقلتُ: ومن الذي أثبَتَ أنَّ معنى القضاء والقدر، سلب الاختيار من العبد، وأنه وثاق قيده الله به الإنسان، حتى لا يملك معه طواعية ولا اختياراً؟
القضاء والقدر، كلمتان يُعبِّران معاً عن علم الله تعالى للأشياء، ووقوعها في الوجود حسب علمه، ليس أكثر. فالقضاء – كما قال علماء هذا الشأن رحمهم الله تعالى – علم الله جلّ جلاله بالأشياء في الأزل على الصورة التي ستوجد عليها. والقدر – وجود تلك الأشياء في عالم الظهور على وجه تفصيلي يوافق القضاء السابق.
فعلاقة قضاء الله تعالى بالأفعال أو الأشياء، ليست سوى علاقة علم بها وكشف لها قبل وقوعها، وهي من لوازم الألوهية التي تعالى بالبداهة. ففي صفاته جلّ جلاله أنه يتعلم بكل ما هو كائن، وما سيكون في الوجود، سواء في الأشياء أو بعضها. وجدت أخيراً على غير الشكل الذي تعلّق به علم الله في الغيب لانقلب علمه جهلاً، وذلك محال في ذات الله تعالى كما هو معلوم.
ومن الأمور الواضحة لكل ذي فكر وعقل، أن مجرّد العلم بوقوع شيء ما – ليس مؤثراً في وجوده، وإنما يوجد ذلك الشيء – على كل حال – بسلسلة علله وأسبابه. إذ لو علم العالم أو جهل الجاهل، تلك حقيقة من أظهر الظاهرات وأوضح الواضحات.
وإنما مثل قضاء الله تعالى في الأشياء – وله المثل الأعلى – كمدرس أُوتِي فراسة وخبرة بحال تلاميذه، ودرجة النشاط والجدّ لدى كلٍّ منهم، فيُسجّل في دفتر مذكراته أنّ فلاناً منهم سيرسب في نهاية العام، وأنّ الآخر سيمتاز وينجح. ثم طوى دفتره، وأقبل إليهم لا يألو جهداً في إرشادهم وتعليمهم ونصحهم، حتى إذا كانت نهاية العام وقع ما كان قد أثبته المدرس وعلم به. أرأيت لو أنّ أحدهم اطّلع على ما كان قد سجّله المدرس لديه في شأن كلٍّ منهم، فراح يقول إنّ الأستاذ أجبر تلاميذه بما قد علم من شأنهم، وأنه سيّرهم بذلك إلى ما انتهوا إليه تسييراً وأرغمهم على ذلك إرغاماً – أيكون هذا الكلام مقبولاً في ميزان عقل أيّ عاقل؟.
وإنما علاقة قضاء الله تعالى بالأفعال التخييرية لخلقه، من هذا القبيل بالضبط والتمام. فهو ليس إلّا علمه بأنّ سبحانه سيخلقك عاقلاً، مريداً، مختاراً، لتكون بذلك مكرّماً على المخلوقات كلها، وأنك ستمارس عقلك وإرادتك واختيارك في مختلف التصرفات والأفعال، فتختار منها: كذا… وكذا… وكذا…
وبيان ذلك، أنَّ الله تبارك وتعالى جهَّز جميع المكلّفين من عباده، بقدر مشترك من الطاقة والعقل والاختيار، جعله مناط التكليف في حقّهم، فنحن إذن تكافأنا لديهم فرص المبادرة إلى تطبيق أوامر الله تعالى والتزام شريعته، ويسيرون في أنهم جميعاً يتعرضون بأصل الأسباب التي تهيئهم للتكليف وتلقّي الأوامر، حتى إذا فقد أحدهم سبباً من هذه الأسباب كالطاقة أو العقل أو الاختيار، انقطعت عنه تبعة التكاليف، واستثني من عموم الجماعة التي يتعلق بها خطاب التكليف من الله عزّ وجلّ.
ولكن الناس بعد أن ينطلقوا من هذا القدر المشترك الذي وضعهم في صفّ واحد، فوق صعيد العدالة الإلهية، يختلفون في مدى استعمالهم للأجهزة التي ملكهم الله إيّاها من عقل وإرادة وطاقة، ويسلكون في ذلك طرائق قِدَداً. فمنهم من يفتح عقله لإدراك آيات الله من حوله، ويستجمع طاقته لتطبيق أوامره وأحكامه، ويستقبل إرادته للاجتهاد نحو جانب الخير، وينظر إلى ما يجلعج في نفسه من الشهوات والأهواء التي تحاول أن تسعى إلى الشرّ. فيمزّق بطرقه السماء، فيقبل على الله في دعاء منكسر يبغض الذنب ويترجّى أن يوفقه الله ويثبته للتمسك بأحكامه.
قال: إذن فما معنى قوله تعالى: «فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ» [فاطر: 8] وقوله: «وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ» [غافر: 33]؟ وفي القرآن الكثير من الآيات الواردة بهذا المعنى، وهي في جملتها تدل على أن الناس إنما يسعدون ويشْقَوْنَ بهداية الله أو إضلاله إيّاهم.
وبيان ذلك، أنَّ الله تبارك وتعالى جهَّز جميع المكلّفين من عباده، بقدر مشترك من الطاقة والعقل والاختيار، جعله مناط التكليف في حقّهم، فنحن إذن تكافأنا لديهم فرص المبادرة إلى تطبيق أوامر الله تعالى والتزام شريعته، ويسيرون في أنهم جميعاً يتعرضون بأصل الأسباب التي تهيئهم للتكليف وتلقّي الأوامر، حتى إذا فقد أحدهم سبباً من هذه الأسباب كالطاقة أو العقل أو الاختيار، انقطعت عنه تبعة التكاليف، واستثني من عموم الجماعة التي يتعلق بها خطاب التكليف من الله عزّ وجلّ.
ولكن الناس بعد أن ينطلقوا من هذا القدر المشترك الذي وضعهم في صفّ واحد، فوق صعيد العدالة الإلهية، يختلفون في مدى استعمالهم للأجهزة التي ملكهم الله إيّاها من عقل وإرادة وطاقة، ويسلكون في ذلك طرائق قِدَداً. فمنهم من يفتح عقله لإدراك آيات الله من حوله، ويستجمع طاقته لتطبيق أوامره وأحكامه، ويستقبل إرادته للاجتهاد نحو جانب الخير، وينظر إلى ما يعتلج في نفسه من الشهوات والأهواء التي تحاول أن تسعى إلى الشرّ، فيمزّق بطرقه السماء، ويقبل على الله في دعاء منكسر يبغض الذنب ويترجّى أن يثبته الله ويقوّيه للتمسّك بأحكامه. ففضل هؤلاء، تراكم الطاعة في أنفسهم وفضلها، فيزيد إلى طاقتهم.
طاقة أخرى من توفيقه، ويزيد إلى عقولهم عقلاً آخر من هدايته، ويضع في إرادتهم معنى العزيمة والإصرار. نجد هذا واضحاً وأفصح في آيات الكتاب الكريم، من مثل قوله عز وجل: «وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى» [مريم: 76]، وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ» [يونس: 9]، وقوله: «وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ» [الشورى: 13]، وقوله: «وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ» [محمد: 17].
ومنهم من يبعد عن أوّل الطريق، فيضع عقله في غطاء من ذكر الله وآياته، ويصرف طاقاته عن القيام بأمر الله وحكمه، ويضع إرادته في أسر شهواته وأهوائه، ويدلّ لكل من يحاول أن يذكّره بطرف من هدى الله وحكمه، أنه مقرّر سلفاً أن لا يفهم شيئاً مما يلقى إليه، وهم الذين
وصفهم الله بقوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» [لقمان: 21]. فهؤلاء هم الذين يجيء بهم مكرم العقل قبل النهاية على الآخرة، فيفهمهم في مزيد من الغواية والضلالة العقلية، ويذيب إرادتهم فيما يصرم عليهم من سيطر الشهوات والأهواء الجانحة، ويبتليهم بمزيد من الانصراف عن موعظة المذكرين وآيات الله في العالمين. نجد هذه السنة الإلهية، وأوضح أيضاً في الكثير من آيات الكتاب المبين. مثل قوله تعالى: «سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا» [الأعراف: 146]، وقوله: «فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ» [الأنعام: 125]، وقوله: «وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ» [البقرة: 26]، وقوله: «وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ» [إبراهيم: 27].