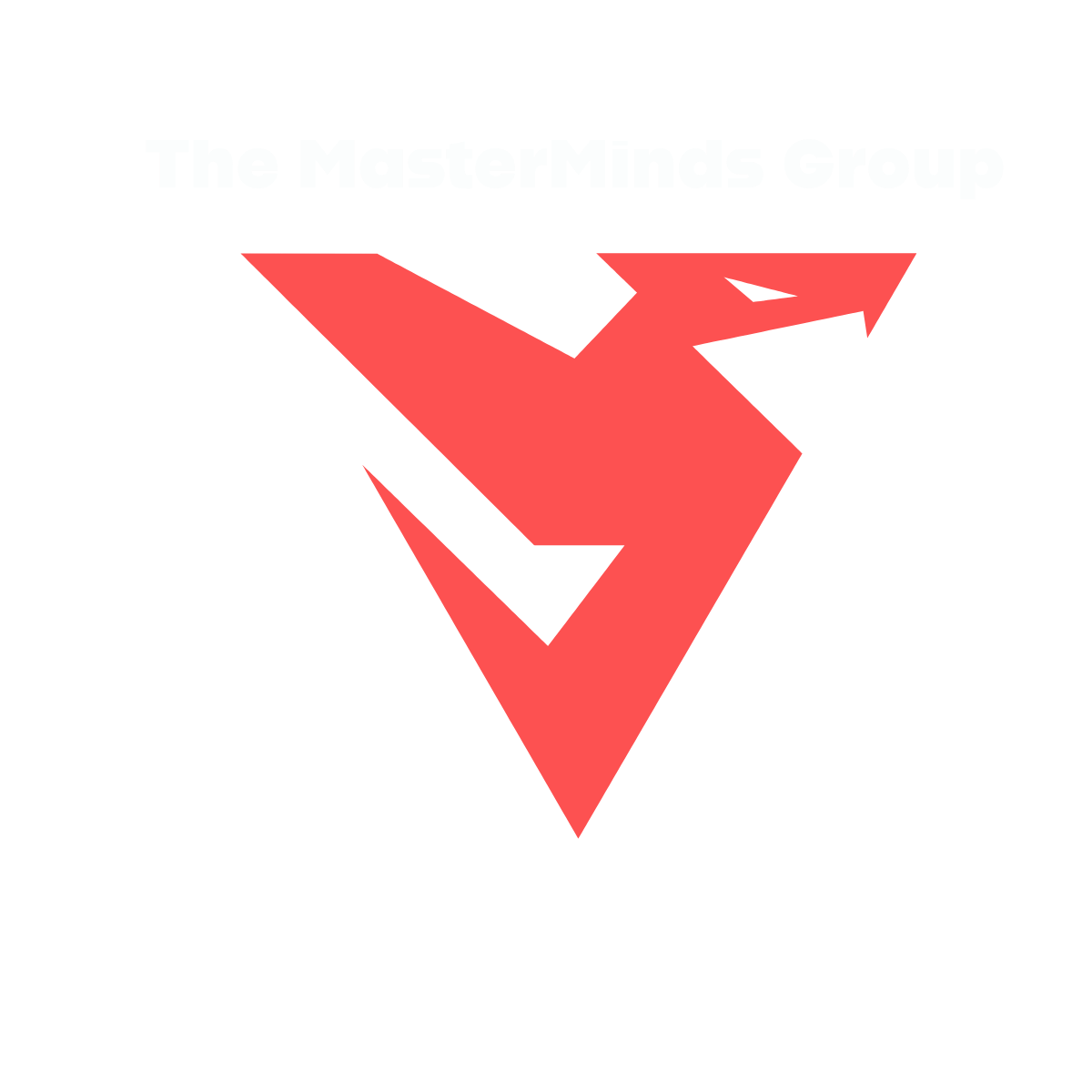التالي هو من كتاب من الفكر والقلب للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

ولقد كان على علماء الشريعة الإسلامية أن يبحثوا مطولا في هذا الموضوع، وذلك عندما راحوا يتأملون الأساس الذي قامت عليه أحكامالشريعة الإسلامية على اختلافها .
فمن المعروف أن هذه الأحكام إنما قامت ضمانا لتحقيق مصالح الإنسان، من حيث هو فرد، ومن حيث هو عضو في المجتمع.
ولكن ما هي المصالح في الشريعة الإسلامية؟
عند هذا السؤال تلاقى علماء الشريعة الإسلامية وعلماء الفلسفةوالأخلاق، إلا أن علماء الشريعة، شقوا إلى معرفة الجواب على هذا السؤال طريقا أسلم، وانتهوا من وراء بحث علمي أن الحسن والقبح في الأشياء اعتبارية، وإن شئت قلت: إنهم انتهوا إلى أن الأشياء بحد ذاتها لا تتضمن حقيقة ما يسمى بشر أو خير.
قالوا: إن «العلاقة» أو الهيئة التركيبية للأشياء مع بعضها، هي التي توصف بكونها خيرا أو شرا، فإذا قطعت العلاقة، أو زالت الهيئة التركيبية، عادت جزئيات الأشياء خالية عن أي مضمون ذاتي لها مما يقال أنه الخير أو الشر، كالقطع المتنائرة لآلة محركة أو طابعة، لا توصف الواحدة منها بأي فائدة أو نفع، ما دامت أنكاثا مجتزاة عن أخواتها. فإذا ما تضامت إلى بعضها، وشملتها جميعا الهيئة التركيبية المطلوبة، تجلى فيها عندئذ معنى الحسن أو الخير، منبثقا من العلاقة القائمة بين تللك القطع المتآلفة.
أي فالصدق، مثلا، ليس خيرا من حيث إنه الكلام المطابق للواقع، ولكله خير من حيث إنه ينسجم مع الوضع الاجتماعي القائم على مقتضيات التعاون والثقة بين أعضائه، ومن حيث إنه يؤدي من أجل ذلك إلى نتائج معينة تنسجم مع ذلك الوضع الاجتماعي .
والعدل، ليس هو التوازن الذي ينشده الناس ويرونه ذروة الحق والخير، إلا لانسجامه مع واقع الحياة الإنسانية المرتبطة بحقوق يتطلبها الطبع البشري، وواجبات يفتقر إليها المجتمع الإنساني، فحاجة الإنسان الى المال هي التي تجعل استلابه ظلما. وحاجة المجتمع إلى ضبط المسؤولية وتنظيم الأسرة هي التي جعلت استلاب الأعراض عدوانا. ولولا هذه الحاجة المستكنة في الطبع أو الآتية من الوضع، لكان العدل لأن لا يرتبط الإنسان بعدل.
فإن وجد حافز من وراء هذه العلاقات التي مثلنا لها، إلى عمل أو سلوك ما، فإنما هو الطبع المجرد. والطبع كما تعلم – صفة تتلبس الإنسان وليست مضمونا ذاتيا لشيء مما يسمى بالخير أو الشر. ولقد اهتم علماء الشريعة الإسلامية، وأقصد منهم بصورة خاصة،
أولك الذين عنوا بأصول الشريعة الإسلامية – بتجلية هذه الحقيقة وإقامة براهين كثيرة عليها، حتى غدت مسألة «الحسن والقبح» عنوانا معروفا لأهم بحث من أبحاث أصول الدين: «علم الكلام»، وأصول الفقه: «منهج البحث والاستنباط في الشريعة الإسلامية».
ولعل أبرع ممن اهتم بكشف هذه الحقيقة وتفنن في بيانها وسوق الأدلة عليها، حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله. فهو الذي سار في
طريق الكشف عنها إلى أن وصل إلى القانون النفسي المعروف والمسمى بالإقران، أو الإشراط، أو رة الفعل الشرطي. وهو القانون الذي لا تزال الكثرة من الناس تربطه باسم العالم الآوسي بافلوف(، وتحسب أنه أول مكتشفي له ومتنبه إليه) .
أوضح الغزالي أم النفس الإنسانية مجبولة على الانسياق وراء الأوهام. وقرر أث الأوهام من شأنها أن تعطي كثيرا من الأشياء صفات غير حقيقية، وذلك بسبب طول اقترانها بما أثبت العقل اتصافه بتلك الصفات. وقد سمى هذه الحالة: (سبق الوهم إلى العكس)، وأوضح كيف إن النفس متى توهمت شيئآ، خدمتها الأعضاء والأعصاب والقوى التي فيها، فتحركت إلى الجهة المتخيلة المطلوبة، حتى إذا تومهمت شيئا طيب المذاق تحلبت الأشداق، وانتهضت القوة المهيجة فياضة باللعاب من معادنه.
وأنت ترى أم هذه هي النظرية ذاتها التي ضج لها العالم واهتم بها علماء النفس عندما قام (بافلوف) بتجربته المشهورة على الكلاب الجائعة، ثم استنتج منها هذا القانون الذي يحسبه بسطاء الناس كشفا عظيما من (بافلوف) لم يسبق إليه.
ثم يبني الغزالي على هذا القانون ما أطال في بيانه علماء الشريعة الإسلامية من آن صفة الحسن والقبح، أو الخير والشر، في الأشياء أمر اعتباري. إذ هي لم تأت إلا لاقترانها بما يميل إليه الطبع، أو بما يتناسق مع وضع التركيب الاجتماعي . فقد أورثها طول هذا الاقتران معنى الحسن أو القبح فيما تتوهمه النفس، حتى وإن انفكت العلاقة بينهما بعد ذلك، إذ إنها قد رسخت في النفس فهي ماثلة فيها.
إن إنقاذ الغريق مثلأأ، من أبرز ما قد يتصوره الإنسان عملا حسنا في ذاته بقطع النظر عن أي ملابسة أو حالة تقترن به. وقد لا يخامر
الشك إنسانا بأن من يقدم على هذا العمل الإنساني العظيم، إنما ينطلق إليه لما فيه من هذا الحسن أو الخير الذاتي وحده دون التفات إلى أي غرض آخر، غير أن هذا الإقدام في حقيقته إنما جاء نتيجة دافع أخر اقترن بعملية الإنقاذ هذه، وقد يكون الدافع واضح في بعض الأحيان وقد يكون خفيا وقد يخفى جدا حتى لا تكاد تشعر به النفس. . المهم هو شي اقترن بعملية الإنقاذ، وليس الإنقاذ ذاته .
ويحلل الغزالي هذه الدوافع، بدءا بما قد يكون ظاهرا منها، ثم الأخفى، فالأخفى، فيقول: إن الدافع إلى إنقاذ الغريق قد يكون الرغبة في اكتساب الثناء من التاس على فعله، وذلك عندما يكون الأمر على مشهد ومرأى منهم، فإن فرض أنه لا يوجد أحد ثمة يمكنه أن يرى عمله هذا، فإن الباعث هو ما قد يتوقعه من تسامع الناس فيما بعد بذلك بالطرق المحتملة، فإن فرضت الواقعة بحالة يستحيل معها أن يسمع أحد من الناس بالأمر، فإت الدافع حينئئذ هو سبق الوهم إلى العكس.
فإن المنقذ قد ألف دائما اقتران مثل هذا العمل بالإكبار والثناء، فتوهم لطول هذا الإلف أن الثناء مقرون به في كل حال، ومن شأن النفس
أن تنقاد لهذا الوهم وأن تتأتر به دون آيا تأمل أو اختيار، ولهذا الدافع الوهمي صورة أخرى توضح الجانب السلبي في الأمر، فإن المنقذ من شأنه، وهو يرى حالة الرجل المشرف على الغرق، أن يقدر نفسه في تلك المحنة، ويقدر غيره معرضا عنه وعن إنقاذه، فيستقبحه منه، فيعود ويقذر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حقي فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم بما يقدم عليه من عملية الإنقاذ.
وقد لا يشعر الإنسان بهذه المراحل من التصور والتقدير، ولكنها تطوف بوهمه بسرعة خاطفة، ثم تسيطر على نفسه وتنطبع بالتأثير على سائر أعضائه .
والسؤال الآن هو:
فإذا كان الأمر هكذا، فما هو الأساس الذي تقوم عليه أحكام الشريعة الإسلامية من حلال وحرام، وفرضي ومندوب ومكروه؟
والجواب:
أن الأحكام الشرعية ليست مبنة على طبائع في الأشياء ذاتها، وإنما هي
استجابة لأمرين اثنين:
أولهما: نوازع الفطرة الإنسانية الأصيلة ،
ثانيهما: العلاقات الإنسانية المتكونة من قيام المجتمع الإنساني على الهيئة التركيبية التي نراه عليها
ولكا كانت الفطرة الإنسانية من صنع خالق الإنسان، وكان هذا الائتلاف في كينونة المجتمع الإنساني، بتنظيمه وتقديره، فقد كان هذا
الخالق المقدر أعلم بالمصلحة التي تغذي فطرة الإنسان ولا تفسدها، وأعلم بالشريعة التي تقيم وضعه الاجتماعي على أقوم أساس وأسلم
طريق، ثم تحرسه من المخاطر التي تجعل انتلافه أنكاثا، وتحيل تركيبه التعاوني إلى تفاعل واحتكاك عدواني .
ولكا علم أئمة الشريعة الإسلامية هذه الحقيقة، عكفوا على كتاب الله وسنة رسوله، يتلمسون فيهما أسس المصالح والمفاسد ليقفوا من وراء ذلك على ميزان كل من الخير والشر في مختلف التصرفات والأفعال، وذلك طبقا لما تقتضيه الفطرة السليمة في الإنسان، ولما يستوجبه الحفاظ على المجتمع الإنساني في أفضل أحواله،
وقد دل استقراء التصرص في كل من الكتاب والستة على جميع المصالح الإنسانية في هذه الحياة نتجمع في كليات خمس، وأن هذه الكليات ينبغي أن تترتب إلى جانب بعضها في سلم يبدأ بالأهم فما دونه على هذا الشكل :
الدين، الحياة، العقل، النسل، المال.
والسبيل إلى تحقيق كل مصلحة من هذء المصالح الكبرى يتدرج في ثلاث مراحل، تبدأ بالأهم فما دونه، وهي: الضروريات، فالحاجيات،فالتحسينيات.
ولو بعثت فكرك أوزاعا في أقطار الأرض كلما؛ وبين الأمم جميعها لما وقفت على مصلحة تخرج من حدود هذه الكليات. ولو أمعنت النظر في أدق القوانين انسجاما وحفاظا على المصالح المختلفة حين تعارضها لما رأيت من سبيل يضمن تألفها دون أن تتخبط ببعضها غير هذا السبيل.
وليس مبعث هذا كله أعيان هذه المصالح، وإنما هو علاقة الانسجام بينها وبين التركيب الاجتماعي الذي أقام الله تعالى حياة الإنسان عليه في هذه الحياة الدنيا . وما دامت الفطرة الإنسانية الأصيلة لا تختلف في جوهرها بين عصر وآخروأمة وأخرى، وما دام الوضع الاجتماعي الذي ينبثق عن هذه الفطرة وضعا ثابت في جوهره تبعا لثبات هذه الفطرة، فإن الكليات المقامة على أساسها ينبغي أن يستمر اعتبارها وترسخ جذورها، ما دام الإنسان إنسان، وما دامت الدنيا التي من حوله هي هذه الدنيا، وما دامت حاجاته الفطرية هي حاجاته ذاتها التي شعر بها منذ أن هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، يتلمس أسباب الحياة من فوقها .
ومهما تطورت الفروع والجزئيات، فلا يعدو أن يكون ذلك تنوعا في شق السبيل إلى هذه المصالح الخمس التي أناط الله تعالى بها سلامة الوضع الإنساني في الأنيا، وسعادة الأبد في العقبى.